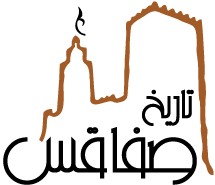صفاقس… أيتها المدينة المسافرة في الحزن والغبار : بقلم رضا القلال

أكثر من 40 سنة وأنت تمسحين الغبار عن وجهك الجميل
هل تسمحون بفتح صندوق الذكريات لنروي تجربتنا مع ملاعق الفرح الكاذب التي سقوها لنا …. :
تبرورة تجرها ذيول الخيبات منذ أكثر من 30 سنة، وكذا المدينة الرياضية.
لم يكن حظ صفاقس إلا نصف محطة قطارات، أصبحت عائقا لفتح كورنيش على شاطئ تبرورة .
ربع مركب ثقافي أطلق عليه لاحقا محمد الجموسي سلب منه المتحف …
مطار يختنق، والسياب زرعت منذ 1952 آلاف فيروسات السرطان…
صحيح أن قاسما مشتركا يربط بين أهالي صفاقس، ولكن كلّ يغنّي على ليلاه، المتزلفين، ووجوه الشمع، والضاحكين بشفاه من البلاستيك، أو الذين لا يزالون في مقاصير المتفرجين … هم الذين فتحوا أبواب المدينة، للتهميش والنسيان والتردي…
وهكذا بعد أن كان الصفاقسية تحت سقف واحد أصبحوا متناثرين كريش العصافير في مهب الريح .
وللأسف تحولت هذه الصورة من نكتة تاريخية إلى شهادة عار معلقة على صدورنا.
صفاقس ذاكرتنا معها ما بعد الاستقلال مسك وعنبر….
عندما نتحدث عن الثقافة نجد أنفسنا أمام قصة مزدحمة بالمنجز….
مدينة شهدت تداخلا مميزا للفنون والآداب والحراك الاجتماعي والثقافي من المكتبات ودور السينما وعمالقة الفكر وكبار المحاضرين ومعارض الرسم…قصة ذاكرة الثقافة تحتاج كتابا كاملا لرصد التجربة وقراءة تفاصيلها
كانت الحركة التشكيلية والمسرحية والموسيقية مشتعلة في دلالة على حضارة هذه المدينة وتميزها الدائم،
الذين احتلونا جعلوا من مدينة صفاقس أجمل وأنظف المدن، وتوجوها بلقب عاصمة الجنوب…وأضافوا اليها قرنا ذهبيا الى جانب القرنين 17 و18. ومنذ ما قبل الاستقلال تحولت صفاقس إلى مدينة ”يشتهيها” كل التونسيين للدراسة والعمل.
فمن الذي دمرنا وأحرقنا وقذفنا إلى المقعد العاشر منذ الثمانينات من القرن العشرين إلى اليوم ؟
صفاقس أصبحت مدينة تقذف بأبنائها المتفوقين إلى خارج المدينة وفي الغالب إلى خارج حدود الوطن، وأصبحت تعذب المقيمين منهم بالفضلات المنتشرة في كل مكان، وبجحيم حركة المرور، وبانقطاع الماء والكهرباء وبالأمراض النفسية من غبار ”الزنق” ورائحة ”الحرق” وغياب التطهير في المنازل، وصخب سهرات الصيف….
مدينة بطحوها على قفاها ازدهرت فيها ”البرارك” و”حلقات” بائعي الشاي و”نصب الفريب”، أكثر مما تشهده من مشاريع عامة ومن برامج ثقافية، ومن قراءة الكتب وترجمتها.
لا ننكر… هذه المدينة اتخذوا بشأنها حشدا من القرارات، هي في الواقع نوع من الكتابة على الماء، أو أنها بصيغة مسرح اللامعقول، ولا يستطيع تفسيرها إلا الله…فتحوّلت صفاقس إلى مسرحية هزلية . ولم نخرج بهذه القرارات التي توالت على امتداد عشرات السنين- وما أكثرها- إلا بالسراب وقبض الريح وأضغاث الأحلام…
صفاقس- باختصار- اختزلوها في دفتر شيكات …وفتحوها للخرفان والأرانب وحوّلوها إلى بحر من الحزن، وهي اليوم وأمام الجميع تضع يدها على رأسها من قسوة الوجع، بعد أن انتقلت من مدينة ساحرة وكوسموبوليتانية/عولمية من قبل أن يسكّ مصطلح العولمة، تتعايش فيها الثقافات والحضارات(1830-1967)، انقلبت الجغرافيا على التاريخ وأصبحت مدينة طاردة لساكنيها إلى غربة الشتات(700 ألف صفاقس بالعاصمة، والصفاقسية تجدهم في أغلب دول العالم). ويمثل جوازالسفر وحقيبة السفر الجاهزة اليوم إحدى ضرورات الحياة بالنسبة للأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والطلبة المتفوقين. وتراجعت صفاقس التي كانت في السابق قلب تونس ومولّدها التجاري والصناعي وسقطت بالنتيجة من أوج القوة إلى العيش على الفتات.
صفاقس…
كانت ملهمة لذكريات ذهبية
صفاقس مدينة ساحلية بدون بحر وجدار من الفوسفوجبس يدمّر بيئتها وصحتها ومستقبلها
تذكّروا السنوات الطيبة في الستينات والسبعينات عندما كنا نستحم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في ”الناتاسيون”، مدرسة تعليم السباحة، وشاطئ الكازينو، وفيريو وقبل ذلك عرفت صفاقس كازينو الجناح الذهبي في ”سان هانري” بمحاذاة ”ستاد سيكلدي” عامر القرقوري حاليا….
من يصدق أن صفاقس تدير ظهرها للبحر؟ وهو الذي صنع ثرواتها، وأحزانها أيضا…الى درجة ان صفاقس الى اليوم تقدم للضيف أكلة السمك بدل اللحم بخلاف كل المدن التونسية الأخرى.
واستحضروا حركية صيّادي السمك في شط القراقنة، والحقول الخضراء في سيدي عبيد، وفسحة 100 متر التي كان يتنزّه فيها الشباب من الجنسين، ولكن البلدية مزّقت أوصالها بأكثر من مشروع فاشل، رغم ان هذه الفسخة تحتل علامة تراث لجيل كامل، تمنع ابجدية الذاكرة الاعتداء عليها، وهذا نسيان ساذج …. ولكن وضعنا الحالي عمّق وجعنا التاريخي والوجودي بعد أن ذهب صراخنا في واد سحيق.
انتهى زمن الفرح في هذه المدينة : عبثوا بمدارسها وساحاتها وحدائقها ومستشفياتها وأطفالها ووضعوها تحت الاقامة الجبرية منذ 40 عاما بعد أن سرقوها وانتقموا منها ولم ينقذوا سفينتها من الغرق.
ماذا سيقول المؤرخون عن هذه الفترة ؟
وماذا يمكن أن نضيف لهذا الكلام الذي لم يحوّل الحبّة إلى قبة، والذي حاول أن يعتمد على منطق التاريخ، ومنطق الزمن:
صفاقس قطعة من دمنا ومن ذاكرتنا….
وأن الصفاقسي أهم من المدينة، فهو الذي يقدر في يوم من الأيام، على تعميرها وإضاءة شموعها. والصفاقسي – كما يعرف الجميع – ذو ”كاراكتار” خاص يتميز بعدة خصائص انتروبولوجية أو خصال مميّزة للشخصية وثوابت إيطيقية، تعرف بالصفات السسيوثقافية. وهو يتكلم بطريقة خاصة وكان له لباسه الخاص. والصفاقسي – وهذا لا يعرفه الكثير- عقلية أيضا يضع الصفقات أو ”شهوة التجارة” في مكانة أعلى من الايديولوجيا.
ومازال هذا الصفاقسي واقف على قدميه، يفدي بالغالي والنفيس، زيتون غاباته ولوزها، ويغذي عبقرية أبنائه من الروضة إلى الجامعة، في نهم استثنائي بالعلم والمعرفة، لهذا صنعها للأدمغة ليس له نظير……عسى أن يعود التاريخ إلى مجراه الطبيعي.
وصفاقس تملك واحدة من سمات المدن ”الكبيرة” وهي القدرة على إعادة اختراع نفسها. ولا يعني هذا أن صفاقس هي المدينة الوحيدة في البلاد التونسية التي تملك هذه الصفات.
كم من مدينة خرجت من رمادها المحترق !
فمتى نرى صفاقس نظيفة يستطيب فيها العيش لكل سكانها، ويتغلغل في تفاصيلها إكسير الجاذبية والثقافة والعلم والفن والتراث؟
رضا القلال