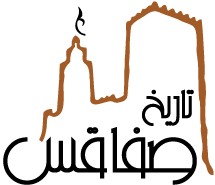جدائل فنيّة في مهبّ الريح …

نفس الرّائحة تعبق من المكان حتّى وإن تنكّر لنا لتعارض وظيفته مع ما يعرض حتّى صرنا نألفه ويألفنا، وكلّما مررنا به تنتعش ذاكرتنا برائحة العناق والقبلات على عتبات القاعة والتي استقبلت هذا العام المائة عمل وسط حشد من الفنّانين في إطار “صالون صفاقس السنوي للفنون” الذي أشعل شمعته السادسة والعشرين يوم 22 فيفري 2020 إلى أن تهبّ ريح مارس الرّبيعيّة فتطفئها ويتصاعد منها دخان بطعم البرتقال.
إنّ تنوّع الخامات والتقنيات في الأعمال المعروضة وتعدّد اختصاصاتها وصيغها لم يكن بالأمر الهيّن الذي سييسّر عمليّة استقرائها بل بالعكس فإنّ في الاختلاف عسر لمحاولة الائتلاف لفرط التقابل والتّضاد والتضاربات بينها، فإن حاولنا تبويبها ضمن ما يسمّى “بالفنّ المعاصر” فإنّ ذلك يجعلنا نمرّ بتعريفه أوّلا حتّى يؤمّن لنا ذلك سلامة وأمن الطّريق من ناحية ومدى تقابلها وتوافقها مع التعريف من ناحية أخرى، فإذا اعتمدنا على تعريف “جون لويس برادال” “Jean- Louis- Pradel” للفنّ المعاصر فهو يعتبر أنّ “الفنّ في النصف الثاني من القرن العشرين لم يتقمّص تعريفا محدّدا بل اكتفى بكونه معاصرا” ، وإنّ ذلك لا يعطينا شرعيّة تصنيف جملة هذه الأعمال وإدراجها ضمن المعاصرة ما عدا بعض الأعمال الفوتوغرافيّة لكريم كمّون، محمّد نجاح، حمدي المعلول، نسرين الغربي، وجدي المكني وسمير الرباعي وغيرهم، باعتبار وأنّ المنعطف المعاصر قد بدأ مع اكتشاف الآلة الفوتوغرافيّة لدرجة أنّ الأميّة أصبحت مرتبطة بمن لا قدرة له على استعمالها وفكّ رموزها وشفراتها وإتقان برمجياتها والتدخّل عليها تقنيّا، لا بمن لا يفقه الكتابة ولا يعرف القراءة. أمّا إذا مررنا بعمل “محمّد الرّقيق” “concept ” يتبيّن لنا بحثه عن النّدرة، الجرأة، التميّز والتفرّد مدرجا إيّاه ضمن “الفنّ المفاهيمي” “l’art conceptuel”، ليتوسّع مجال قراءته ويستفزّ الآخر الذي يجد نفسه أمام محاولة في القطع مع الكلاسيكيّ من ناحية التّقنية (تقنية التقطيع) تحت سطوة ثنائيّة “الكشف والحجب”، وتجاوز المعهود المعروض من ناحية المادّة باختلاف تركيباتها وخلطتها ( ألوان، قطعة حاشية، قرطاس، خيط، قماش..) دون أن ننسى حضور الكتابة في محاولة تتأرجح بين التوق للحريّة الفنيّة وبين “شمع أحمر” يحدّ منها ويحجّرها انعكاسا لبعض الظّروف التي ربّما تكون عائقا أمام الولوج في عالم المعاصرة لعلّها ظروف سوسيو- ثقافيّة تعود للهويّة والجذور وتمسّك الفنّان العربي بها.
لئن اتّحدت باقي الأعمال لوجدت لها طريقا يجمعها ويحرّرها في الآن ذاته حسب اختصاصاتها ومجالاتها التعبيريّة فإنّ طريق الخزف ظلّ مألوفا ومعهودا، طريقا معبّدة دون مطبّات ولا مغامرات تجعله لا يخرج عنها ويشقّ أدغال التمرّد والانعتاق والانفتاح نحو تجارب جريئة لتدخل بوتقة المعاصرة ففي عمل “بلحسن الكشو” “عبير الأمل”، ورغم إتقانه للتّقنيات وإخراجه لخلطة رفيعة من الألوان ونجاحه في تقديم تكوينات حائطيّة فيها من التوازن والحبكة الفنيّة في التأليف بين عناصرها، إلاّ أنّ رائحتها ظلّت كما هي وكما عهدتها أنوفنا وكما ألفتها أعيننا في كلّ مناسبة، مثلها مثل المنحوتات التي أثّثت المكان رغم اختلافها في مجابهة المادّة وقساوتها من خشب ورخام والتي لا ننكر أنّها أضافت تنوّعا على مستوى تعدّد الاختصاصات إلاّ أنّها ظلّت صامدة جاثمة وسط قاعة الأفراح كعروس مكرهة على الزواج.
إنّ ذلك لا يمنع من وجود خيط رفيع يربط بين جملة من الأعمال حتّى يتلاشى مع مجموعة أخرى لفرط شفافيته فيقطعه “طائر الفينيق” لرضا الغالي باحثا عن طيور أخرى ليكتمل السرب فيحلّق ليجدها عند “هالة الهذيلي” في عملها “نساء القمر” وعند “نجوى عبد المقصود” في عملها “ساكنه الهوى” والتي عمدت إلى تقسيم عملها إلى عالم حالم وعالم واقعيّ، فما إن تغوص بين ثنايا هذا العمل حتّى يتبيّن لك منذ الوهلة الأولى التناقض بين العالمين وهو ما يظهر جليّا من خلال الألوان المتقابلة والمتباينة، فما إن غلبت الألوان الدّاكنة على العالم الدّنيوي السفلي (معمار، مدينة …) حتّى تلاشت وأصبحت أكثر شفافيّة في عالم حالم علويّ هجين يجمع بين “الإنسانيّ والحيوانيّ” سبحت معهم “نجوى” في فضاء رحب أين تعالق “السّمائي بالبحري” حتّى اضمحلّ الخط الفاصل بينهما فعكس سبّاحة ماهرة في عالمها جعلت من الفرشاة طوق نجاتها تحملها إلى عوالم أخرى حيث لا يتوقّف البحر عن التمثّل والامتثال كعالم “الصّياد” لدى “نجيب بو صباح” وعالم “رفيق القسنطيني” المعنون “من بحرو” وعالم “عائدة الكشو” “Flux d’energie” ، فتجد نفسك تسبح في طبقات من المعنى داخل هذا العالم السّحري الحالم فيبعث فيك أملا ورغبة في الحياة حتّى تفيق من غفوتك وتحطّ الرّحال أمام عالم من الأشباح، عالم غرائبي وعجائبي يجمع بين الرّائع (على مستوى التقنية واختيار الألوان والخطوط واختلافها) والمروّع (الشّخوص الماثلة، الأشباح، الهالات …) مع “فاطمة دمّق” لتلفي روحك في عالم أسطوريّ مع عملها “سحر أسطوريّ” وسحر تكويناتها فتذهلك بهذا الفضاء الخارق والخياليّ بامتياز عالم مليء بالرّموز والعلامات فما إن تغوص في ثناياه حتّى تتلاشى فرحة المكان وتخال لوهلة أنّك بطل أسطورة يونانيّة لكن رغم اختلاف العوالم في هذه الأعمال إلاّ أنّها ظلّت القاسم المشترك الذي يؤلّف بينها .
تتواصل عمليّة التقصي بحثا عن نفس معاصر يشفي غليل زائرِ معرضٍ فنيّ في القرن الواحد والعشرين، باحثا عن “فعل” وعن “ردّة فعل” فتفاعل فتقلّصٍ في المسافة بين الأثر الفنّي والمتلقّي بين ارتجال وجرأة والإيمان بأنّ “الإبداع اصطناع للصّدمة والفضيحة” ، طريق من المحتمل نحو اللاّمحتمل، ومن المحدود نحو اللاّمحدود وبالتالي أولويّة الموقف على المعرفة والتقنية لكن دون جدوى. وبعد تحليلنا لجملة الأعمال التي سبق ذكرها نصرّ في العودة للتعريف بالفنّ المعاصر تبرئة لأنفسنا في إطلاق الأحكام خاصّة وأنّ مشكلة التصنيف من الإشكاليات القائمة اليوم والتي تفرز الأسئلة التالية: من له الحقّ في التصنيف؟ وماهي مقوّماته وآلياته وتقنياته؟ وعلى أيّ أساس يصنّف العمل الفنّي اليوم؟ إذن في تقديم أسعد عرابي للفنّ المعاصر وتحوّلاته يقرّ بأنّه “يعتمد منذ دادائيته الأولى … تدمير تقاليد السّطح التصويري وإلغاء مفهوم لوحة الحامل (…) ثمّ بدأ التّحوّل باتّجاه شيئيّة هذه العناصر عن طريق التعشيق “l’assemblage” ثمّ الإنشاءات “les installations” ثمّ البرفورمونس “performance” ” ، إلاّ أنّنا لم نجد من هذه الأخيرة غير “أثرها” مع “أثر 1″ و” أثر 2″ ” لفاطمة الزّهراء الحاجي” في تخليدها للفعل الغابر (الزّائل) “l’éphémère” كمحاولة لتحنيط الزّمن والقبض على لحظات هاربة من زمن العرض وتثبيتا لتمثّلات جسدها، لكن هل نجحت هذه الآثار المعروضة (الملابس التي كانت ترتديها أثناء العرض الملطّخة بالألوان) في الحفاظ على سحر اللّحظة وهالة العرض أثناء “المرور للفعل”؟ أم تكبّلها داخل إطار جعل من المسافة الفاصلة قائمة بين العمل والمتلقّي دونما تدخّل وتفاعل؟ لا ننكر أنّ ذكاء الفنّانة في اعتمادها على خلفيّة مرآتيّة جعل من الآخر شريكا ولو بصفة غير مباشرة بانعكاسه على سطحها وغزوه للعمل واحتسابه جزءا لا يتجزّأ منه فيكون مشاهدا وفاعلا في نفس الوقت بتمثّله داخلها، لكن يبقى التدخّل محدودا يحدّده إطار لا يمكن التملّص منه في زواياه الأربع، ويظلّ الآخر مجرّد شبح ما يلبث في الظّهور حتّى يمّحي، أجساد مارّة دون أن تترك أثر تختلف تعابير وجهها في وضعيات وحالات مختلفة منها الفازعة والمتذمّرة والضّاحكة، فرديّة جماعيّة تتماهى مع الشّطحات المتتالية للأجساد المنفلتة في المكان والزّمان باحثة عن بصمة لها في الزّمن فيتكوّن وينشأ الحدث ولو صمتا، كما يجب أن نعي أيضا تلك المساحة الملغاة الفارغة بين الطرفين التي تخلط بين الحلم والتجربة الحسّاسة المعتمدة بدرجة أولى.
لذلك يبقى عامل “الحدث” في”العرض” مفقودا لم يستطع إخراجنا من هول “الرّوتيني” في “الفنّي” والتكرار التّعسّفي لأنماط فنيّة خالية من عنصر المفاجأة ومن عالم خال من التّجدّد فالتشارك في الفعل بتعميم الحقّ سواء في المبادرة أو الفعل يجعل من ثنائيّة الفنّان” و”المتلقّي” “كليّة” إن صحّ التعبير “فالأنا ليس الكائن الذي يبقى في وجوده هو عينه بل الكائن الذي يرتكز وجوده على التماهي وعلى البحث عن هويّته من خلال كلّ ما يحدث له” ليصبح التلاقي “la rencontre” والتلاقي وجها لوجه من أهمّ مقوّمات العرض ولتبدأ “الأنا” في التّجلّي للآخر بعيدا عن الزّيف بل بكلّ نزاهة في مباشرة الفعل. إذن يجب على الآخر أن يخضع لوضع المرور الذي هو في حدّ ذاته رفض كلّ ذوبان في المطلق وتعابير الوجه هي التي تؤكّد مروره من حالة لحالة ومن وضعيّة لأخرى وهو ما يتّفق مع معايير المعاصرة في تذويب الشّخصي في الجماعي وتذويب الفردي في العمومي من خلال تماهي وتقارب الأجساد والتحامها ببعض. أمّا فيما يخصّ التنصيبة كنمط فنّي معاصر فنجد محاولة “إيمان القطّي” “موت عند الولادة” قد لامست هذا النمط دون أن تصل إلى الإشباع في بلوغ قمّة التنصيب فكانت أقرب إلى التنضيد والتوظيب دون أن ننسى مباركة نجاحها في نقل “اليومي” من خلال العروج على قضاياه “قضايا الرّضع” فكان “مناخا” (خيوط متشابكة، لون أحمر إشارة إلى الدم، حالة إنعاش …) ساهم في تكوين إطار فنّي- فكري/ ثقافي- واقعي يتعلّق تعلّقا وثيقا بالمجتمع معبّرة عنه وما يشوبه من تحوّلات ومشاكل وهو ما يثير في المشاهد انفعالا جماليّا- إدراكيّا لفرط العلاقة بين ماهو فنّي وواقعي معاش فتجد الفنّانة نفسها في منطقة “الما بين” “l’entre deux” وهي المنطقة التي توجد بين عالمين اثنين “عالم روحي” وآخر “مادّي” وهكذا يصرّ أن يكون التصنيف وفقا للعوالم المختلفة داخل عالم الأفراح عمادا وثبوتا في تبويبها.
وإذا كانت “الفاصلة” في عالم النّصوص كإشارة للفصل بين الصّفات ووجوبا لأخذ نفس فإنّ “نقطة- فاصلة” “point- virgule” “لأنيس بن سالم” تجبرنا على الوقوف لا بل التوقّف في مراجعة أصل الشيء، زمانه ومكانه ووجوب التوسّع في قاعدة الاختيارات فما أحوجنا اليوم إلى أعمال متمسّكة بزخم الحادث في فاعليّة تحوّلاته وممكناته فيفعّل بالتالي قدراته وإمكاناته ويذعن للامحتمل وللصّادم والطّارئ والانفتاح أمام المبادرة في إنجاز نقلة تتخطّى الحديث وتعطي أولويّة للمشروع على حساب الأغراض تشترط الجرأة والمجازفة فما فائدة الأغراض والوسائط إن كنّا فاقدين للمشروع ؟ لنجد كلّ ذلك يتعارض مع التوازن والتضارع والتماثل مقابل هاجس المجموعة في ضمان الأمن والأمان والانتظام بمواصفات “صنع في تونس” “made in Tunisia” ونضنّ أنّه قد حان الوقت لمراجعة العلاقة بين “فكّر” و”عاش” فالوقوف أمام قماشة بيضاء ليس تماما كالالتقاء مباشرة بالجمهور.
ياسمين الحضري
——————————————
1- “Lors de la deuxième moitié du 20 eme siècle, l’art n’a pas pris une définition précise, mais il s’est limité à être contemporain” . Jean- Louis- Pradel, Larousse, 2004 page8.
2- محمّد محسن الزّارعي، مقال بعنوان “في استطيقا المتنافر”، المجلّة التونسيّة للدّراسات الجماليّة، العدد الأوّل صفحة 40.
3- أسعد عرابي، نصّ ما بعد الحداثة، الصّراع بين الفنون،العربي العدد 592 صفحة 106.
4- « Le Moi, ce n’est pas un être qui reste toujours le même, mais l’être dont l’exixter consiste à s’identifier à retrouver son identité à travers tout ce qui lui arrive » Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Kluwer Academic , 1996, page 25.
المراجع
المراجع بالعربيّة:
– أسعد عرابي، نصّ ما بعد الحداثة، الصّراع بين الفنون،العربي العدد 592 .
– محمّد محسن الزّارعي، مقال بعنوان “في استطيقا المتنافر”، المجلّة التونسيّة للدّراسات الجماليّة، العدد الأوّل.
المراجع بالفرنسيّة:
– Emmanuel Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur l’extériorité, Kluwer Academic , 1996.
– Jean- Louis- Pradel, Larousse, 2004.